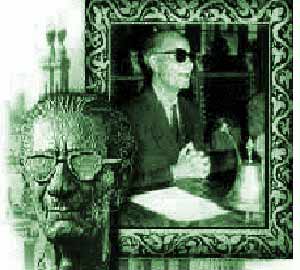وعلى ذكر هذا التحمس الطَّاهَوِيّ لليونان ومستعمراتهم ينظرون شَزْرًا إلى دين الإسلام ويجأرون بأنه دينٌ أجنبيٌّ وأن الذين يؤمنون به هم أيضًا أجانب ينبغي أن يعودوا من حيث أَتَوْا فهم مجانين ليس لهم من مكان يليق بهم إلا في الخانكة! وقد كان المظنون أن تقول ذلك الأغلبيةُ المسلمةُ لغيرها، لكن المسلمين لا يمكن أن يفكروا على هذا النحو الإجرامي البليد، بل يقولون إنَّ مصر بلد الطائفتين! وعلى أية حالٍ فلم يقل أي من الفريقين، فيما نعلم، إنه صاحب عقلية أوروبية، اللهم إلا طه حسين من بين مَن ينتسبون للإسلام، اليونان وتأثير اليونان الفكري في مصر الفرعونية أنقل للقارئ هذه السطور التي تصف فيها زوجتُه بعضَ ما كان يفعله في شتاء 1939م في تونا الجبل برفقة سامي جبرة المسئول عن الآثار هناك: "وكان طه، الذي ظل مسئولاً أمدًا طويلاً عن كافة أراضي الحفريات، يحب على نحوٍ خاصٍّ هذه الأرض التي كانت تبدو له وكأنها تخصه، فقد كان يجد فيها حضارة يحبها ما دام العالم الفرعوني كان يتحول هنا تحت تأثير الاندفاعة الهيلينية. كانت موميات القرود في الأنفاق تهمُّه بشكلٍ عابر، غير أنه كان يتوقف في معبد بيتوزيريس. كان يمشى ببطء بين أكثر القبور تواضعًا أو بين النصب الجنائزية. وذات يوم دخلنا إلى واحد من هذه القبور.
كان يشبه القبورَ الأخرى بدَرَجه الخارجي الضيق. صعدنا إلى الغرفة الصغيرة، وكان قد وُضِع فيها قديمًا جسدٌ نحيفٌ لفتاة كانت قد ألقت بنفسها في النيل، اسمها "إيزيدورا"، وتقول الكتابة الموجودة على قبرها إنَّ أباها قد طلب من أجلها القرابين والصلوات. وفجأةً لاحظتُ أنَّ طه ابتعد عنا، ثم طلب إلينا أن نحمل إليه مصباحًا قديمًا (وكان ذلك متوافرًا)، وأن نشعله بالبَخُور وأن نستمر في إشعاله. لم يعد سامي يُدِير أشغال تونا، ولا أدري إذا كان مصباح إيزيدورا لا يزال يشتعل أحيانًا" (سوزان طه حسين/ معك/ 135- 136).
وقبل أن أمضي أحب أن أتساءل: ما كل هذه الرقة والحِنِّيَّة والرهافة العاطفية؟ أين التنوير والتفكير العلمي الذي يصدع أدمغتنا به حواريُّو طه حسين، وهم يَرَوْنه يشعل مصباحًا لإيزيدورا المسكينة التي ماتت من آلاف السنين؛ استجابةً لرغبة أبيها في تقديم القرابين ورفع الابتهالات للآلهة؟ أم أن التمرد (التنويرى) لا يكون إلا في مواجهة دين محمد الطاهر النظيف من ظلمات الوثنية ونجاسات الخرافة؟
إنَّ الدكتور طه يلجأ إلى حيلة مكشوفة من حِيَل العيال الصغار حين يقول إن فريقًا من المصريين يريدون أن يُلْحِقونا بالشرق، مع أننا لا ننتمي إلى الصين أو فيتنام أو اليابان، فكيف يحسب هؤلاء أننا شرقيون؟ ثم يذهب فيدلل على أنه لا شيء في ثقافتنا يربطنا بهذه الأمم.
وهي، كما قلتُ، حيلة مكشوفة من حِيَل العيال الصغار، إذ مَنْ بالله من المصريين أو من غير المصريين من أهل منطقتنا هذه يقول إننا شرقيون بذلك المعنى؟ أتحدى طه حسين أو غير طه حسين أن يأتي لي بمن يقول هذا! إن الذين يقولون بشرقيتنا إنما يقصدون أننا عرب مسلمون، فنحن جزء من الشرق العربي المسلم كما يعرف ذلك كل أحد، على حين يَتَبَالَهُ طه حسين ظنًّا منه أنه من الذكاء بحيث يمكن أن يخدعنا في أمرٍ مكشوفٍ بل مفضوحٍ كهذا، وأننا من الغباء بحيث يمكن أن نبلع بسهولةٍ هذا الطُّعْم الخائب! إن الرجل هنا إنما يُسَفْسِط، وأي سفسطة؟ إنها سفسطة ملعونة مخربة مدمرة، وهو يمارسها بكل جرأة وبرود أعصاب وجمود وجه متظاهرًا بالبراءة التامة، وهو أبعد ما يكون عن البراءة!
يقول بسفسطته التي لا تُضارعها سفسطة أخرى: "وأنا من أشد الناس زهدًا في الوهم وانصرافًا عن الصور الكاذبة التي لا تصوِّر شيئًا، وأنا مقتنع بأن الله وحده هو القادر على أن يخلق شيئًا من لا شيء، فأما الناس فإنهم لا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه. وأنا من أجل هذا مؤمنٌ بأنَّ مصرَ الجديدة لن تُبْتَكَر ابتكارًا، ولن تُخْتَرَع اختراعًا، ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة، وبأن مستقبل الثقافة في مصر لن يكون إلا امتدادًا صالحًا راقيًا ممتازًا لحاضرها المتواضع المتهالك الضعيف. ومن أجل هذا لا أحب أن نفكر في مستقبل الثقافة في مصر إلا على ضوء ماضيها البعيد وحاضرها القريب، لأننا لا نريد ولا نستطيع أن نقطع ما بين ماضينا وحاضرنا من صلة، وبمقدار ما نُقِيم حياتنا المستقبلية على حياتنا الماضية والحاضرة نجنِّب أنفسنا كثيرًا من الأخطارِ التي تنشأ عن الشططِ وسوء التقدير والاستسلام للأوهامِ والاسترسال مع الاحلام! ولكن المسألة الخطيرة حقًّا والتي لا بد من أن نُجَلِّيَها لأنفسنا تجليةً تزيل عنها كل شك، وتعصمها من كل لَبْس، وتُبْرِئها من كل ريب، هي أن نعرف أَمِصْر من الشرق أم من الغرب. وأنا لا أريد بالطبع الشرق الجغرافي والغرب الجغرافي، وإنما الشرق الثقافي والغرب الثقافي. فقد يظهر أن في الأرض نوعين من الثقافة يختلفان أشد الاختلاف، ويتصل بينهما صراع بغيض، ولا يَلْقَي كل منهما صاحبه إلا محاربًا أو متهيئًا للحرب. أحد هذين النوعين هذا الذي نجده في أوروبا منذ العصور القديمة، والآخر هذا الذي نجده في أقصي الشرق منذ العصور القديمة أيضًا. وقد نستطيع أن نضع هذه المسألة وضعًا واضحًا قريبًا يُدْنِيها إلى الأذهان وييسِّرها على الألباب: فهل العقل المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟، أم هل هو غربي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟ وبعبارة موجزة جليَّة: أيهما أيسر على العقل المصرى: أن يفهم الرجلَ الصينيَّ أو اليابانىيَ، أو أن يفهم الرجلَ الفرنسي أو الإنجليزي؟" (ص16- 17).
أرأيت أيها القارئ الكريم كيف يضع طه حسين المسألة؟ إنَّ مصر إما أن تكون بلدًا شرقيًّا كالصين واليابان وفيتنام، وإما أن تكون بلدًا أوربيًّا، وكأنه لا يوجد من الشرق إلا الشرق الأقصى، فلا شام ولا جزيرة عرب ولا إيران ولا باكستان ولا أفغانستان ولا دول أواسط آسيا المسلمة ولا ليبيا ولا تونس ولا الجزائر التي كانت حبيبتُه فرنسا تحتلها وتعمل على إخراجها عن عروبتها وإسلامها، ولا المغرب ولا موريتانيا ولا السودان ولا الصومال ولا إريتريا ولا بقية أفريقيا الموحِّدة التي تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. كذلك من الجليّ الذي لا يحتاج إلى تنبيه إليه أن طه حسين يتجاهل تجاهلاً تامًّا تاريخ مصر الإسلامي، وهو الذي لا تعرف الأغلبيةُ الساحقةُ الماحقةُ من المصريين لها تاريخًا غيره، فتراه يرجع بعيدًا بعيدًا إلى التاريخ القديم الذي كانت مصر متصلة فيه بالإغريق، ثم يقفز قفزة عالية هائلة فوق القرون المتطاولة التي عاشتها مصر في نور الإسلام لينزل على جذور رقبته في العصر الحديث الذي كانت إنجلترا تحتل فيه أرض الكنانة وتلتزم مصر باتفاقيات مع الدول الأوربية تجبرها على أن تنحو في تعليمها وإدارتها وتشريعاتها وسياستها مَنَاحِيَ لا تنسجم، إن لم تتعارض تعارضًا عنيفًا، مع ثقافتها ودينها ولا يفكر هو في الدعوة إلى الانعتاق منها بل بالعكس يرى أن على مصر الوفاء بها (ص45- 46، 82، 88، 91- 92 مثلا)! ولأنه بهلوان بارع فإنه يقوم من السقطة دون أن تنكسر له رقبة، ذلك أن أصحاب السيرك قد وضعوا له الحشايا الإسفنجية التي تتلقاه عند سقوطه من حالقٍ تلقيًا حنونًا، لا حبًّا فيه، وإنما فتنةً لنا، نحن المتفرجين البُلْه، عن ديننا وثقافتنا واتجاهنا الروحي والسياسي!
وقد غاظ هذا التقسيمُ البهلوانيُّ المرحومَ سيد قطب فكتب ينتقد صاحبَه قائلاً: "ووَضْعُ المسألة على هذا النحو تتجلى فيه كل مهارة الدكتور في المناقشة، فهو قد قسَّم الدنيا قسمين اثنين لا ثالث لهما: قسم تمثله الصين واليابان، وإن شئت فضُمَّ إليهما الهند وإندونيسيا، وقسم تُمثله فرنسا وإنجلترا، وإن شئت فضُمَّ إليهما كل دول أوروبا وأمريكا.. فلا بدَّ، للإجابةِ عن سؤال الدكتور على هذا الوضع، أن تكون مصر أمة غربية لأنها، بلا تردد ودون شك، تَفْهَم الإنجليزيَّ والفرنسيَّ أكثر مما تَفْهَم الصينيَّ واليابانيَّ في هذا الزمان!
وهذا ما قصد إليه الدكتور من توجيه السؤال على هذا المنوال! ولكن لا ريب أن وجه المسألة يتغير لو كان الشرق الذي يواجهك به غير الصين واليابان والهند وإندونيسيا. أي لو كان هناك قسم ثالث للدنيا يُمثله الشرق العربي والغرب العربي، ومصر بينهما حلقة الاتصال. ثم يزداد وجه المسألة تغيرًا لو كانت الدنيا أكثر أقسامًا حسب عقلياتها المختلفة، وهو الواقع، فكانت أوروبا وأمريكا تنقسمان بحسب العقلية الديمقراطية والعقلية الديكتاتورية، وبينهما خلاف أساسي لا شكَّ فيه، وكان الشرق ينقسم بحسب أجناسه، وهي كثيرة، وحسب طبيعة بلاده، وهي متغايرة.. إلى آخر الأقسام التي لا بد أن يفطن إليها ويدقق في تمحيصها من يريد وضع مناهج الثقافة حسب العقليات" (سيد قطب/ نقد كتاب "مستقبل الثقافة في مصر"/ الدار السعودية للنشر والتوزيع/ 1389هـ- 1968م/ 12- 13).
كذلك يقول الأستاذ الدكتور بسفسطته المعهودة إنَّ العلاقةَ بين الغرب الأوروبي والشرق الأقصى كانت دائمًا علاقة صراع وحروب، متناسيًا أنه لم تكن هناك أية علاقات بين هذين القطبين في التاريخ القديم ألبتة، أما نحن فمنذ القديم لم تكن لنا بالغرب من علاقة إلا علاقة الصدام الدموي، وبخاصة بعد الإسلام بدءًا بالحروب بينه وبين الدولة البيزنطية التي استطاع الدين الحنيف أن يكسحها من المنطقة إلى الأبد، ومرورًا بالحروب الصليبية التي كسبت فيها أوروبا الجولة الأولى إلى أن تمكَّن المسلمون من لملمةِ شعثهم وتضميد جراحاتهم ثم تلقين أولئك الأوغاد آلم درس خبروه في حياتهم وأعادوا هذا الواغش البشري إلى مقالب الزبالة التي كان قد جاء منها، وكذلك محاكم التفتيش التي ذاق المسلمون على أيدي جلاديها المتوحشين ما لم يذقه بشر حتى تم اقتلاعهم من دينهم وبلادهم، وانتهاءً بالاستعمار الأوروبي الذي بسط لعدة عقودٍ سلطانه على المنطقة وأذلها واستغلها أبشع الإذلال والاستغلال، وما زال يبسط سلطانه الإجرامي على بعض أقطارها مثل فلسطين وأفغانستان والعراق.. فمتى يا تُرى كانت العلاقة بيننا وبين الغرب أيها السوفسطائي علاقة تفاهم وتعاون؟ إنك ومن هم على شاكلتك لستم حَكَمًا على أممكم، فأمثالكم في كل مكان وزمان إنما ينحازون إلى الأجنبي ويبيعون أنفسهم له رِخَاصًا مقابل عَرَضٍ من الدنيا تافةٍ ضئيل! بل لقد كانت علاقة أوروبا بعضها ببعض علاقة خصام وسفك دماء في كثير من الأحيان، وما الحربان العالميتان منا ببعيد! لكن السوفسطائيين قوم يتبالهون ويَسْتَبْلِهون! أعاذنا الله من السفسطة والسوفسطائيين!
والغريب أن د. طه لا ينكر أن مصر كان لها علاقات ببعض دول الشرق الأدنى (بعضها فقط كما يريد منا أن نفهم، وهي الشام والعراق، فلا كلامَ عن السودان ولا الصومال ولا ليبيا ولا غيرها من دول الشمال الإفريقي، وكان الله يحب المحسنين!)، لكن أي مصر؟ إنها مصر الفرعونية، وليست مصر العربية المسلمة التي لا نعرف انتماءً لغيرها الآن، كما أن هذه العلاقات لا تشفع عنده لكي تُعَدَّ مصر بلدًا شرقيًّا رغم ذلك مع أن الوضع هنا هو نفسه في حالة الإغريق، بل إن الصلات هنا أكثر وأشد على الأقل بحكم الجوار المباشر الذي لا يفصلنا فيه عن تلك الدول بحر ولا مزاج نفسي وحضاري مختلف أشد الاختلاف (ص19- 20).
فلماذا يا ترى؟ إن هذا يذكرِّنا بالمثل الشائع: "عنزة ولو طارت!"، كما يذكِّرنا بقصة ذلك الرجل الجاحد للجميل والذي سبق أن عُومل أثناء اغترابه في بلدٍ من البلاد على يد رجل من أهل ذلك البلد معاملةً غايةً في الكرم والجود، فوعد مُكْرِمَه أنه متى أتى إلى بلده فسوف يرد إليه الجميل أضعافًا.. ثم حدث أن ساقت الظروف هذا المحسِن إلى بلد الجاحد فذهب إليه آملاً في أن يجد لديه ما يُزيل عنه الشعور بالغربة ووحشتها، لكن صاحبنا أوقفه على الباب، وأخذ يتطلع إليه ويتباله منكرًا أنه يعرفه أو سبق له أن رآه، والمسكين يخلع مرةً قلنسوته، ومرة برنسه، لعل ذلك يساعد الرجل على وضوح الرؤية والتذكر.. فما كان من صاحب البيت إلا أن أسرع قائلاً اختصارًا للجهد والوقت وتيئيسًا للضيف أن ينتظر منه أية معاملة كريمة: أَرِحْ نفسك يا أخي، فوالله لو أنك خرجت من جلدك نفسه ما عرفتُك!
ثم إنَّ العبرةَ على كلِّ حال بشعورِ الشعب وموقفه من علاقات مصر بالدول الأخرى: لقد ظل المصريون ينظرون إلى الإغريق على أنهم محتلون غرباء، فلم يندمجوا فيهم ولا اصطنعوا لغتهم ولا أخذوا عنهم دينهم ولا تثقفوا بثقافتهم، بخلاف ما فعلوا مع العرب حين أتوهم بالإسلام، فقد تعربوا مثلهم لغة وثقافة، وأقبلوا على الدين الذي جاؤوهم به واعتنقوه وتفانَوْا في التمسك به والدفاع عنه فكريًّا وعسكريًّا.. ولا يظنَّنَّ ظانٌّ أن ذلك كان سببه حكم العرب لمصر، فقد احتل الإغريق وغير الإغريق مصر وحكموها فلم تسلس مصر قيادها لهم ولم تقتبس منهم لغتهم ولا دينهم ولا عاداتهم وتقاليدهم كما قلنا، كما أنَّ العربَ سرعان ما خلَفهم في حكمِ مصر الطولونيون مرةً، والإخشيد أخرى، والفاطميون ثالثة، والأيوبيون الأكراد رابعة، والمماليك الأوروبيون خامسة، والعثمانيون الأتراك سادسة، لكنها خلال تلك النظم السياسية لم يحدث قط أن فكَّرت في نبذِ الإسلام أو اللسان الذي نزل به كِتَاب الإسلام، بل ظلت قلبًا وقالبًا وروحًا وعقلاً وشعورًا وخلقًا وتشريعًا وعاداتٍ وتقاليدَ بلدًا إسلاميًّا، كما لم يفكر أي من هؤلاءِ الحكام في نبذِ الإسلام أو لسانه، اللهم إلا إنَّ العثمانيين قد فرضوا لغتهم في أواخر عهدهم في بعض مجالاتِ الإدارة، لكنْ سرعان ما انفصلت مصر عنهم عقب ذلك وعادت العربية إلى تألقها كَرَّةً ثانية لم يكسف من نورها خطة الإنجليز في جعل قسمٍ من مناهج التعليم بلغتهم. بل لقد أصبح يُنْظَر إلى أرض الكِنَانة منذ قرون على أنها زعيمة العالم العربي والإسلامي.
ثم يريدنا الدكتور طه حسين الصعيدي الأزهري، لمجرد أنه ذهب إلى أوروبا والتقطه الأوروبيون وجعلوا منه صنيعة لهم لقاء ثمنٍ دنيويٍّ بخسٍ، أن ننزل على سفسطته وننسى هذا كله ونلقى بتلك الكنوز والمكاسب في البحر ونذهب فنرتمي على أقدام أوروبا نستعطفها ونُقبِّل حذاءها حتى ترضى عنَّا وتقبلنا أتباعًا أذلاء لها! أي منطق يقول بهذا يا إلهي؟ وأي عقلٍ يمكن أن يظن أنه ينجح في إقناعِ المصريين بهذا؟ لا يا دكتور طه، يفتح الله! إن طه حسين يريد أن يسوِّق لنا الوهم الكذوب فيزعم أن العلاقة بين مصر واليونان في التاريخ القديم كانت علاقة تفاهم ومودة حتى عندما كانت لها مستعمرات في بلادنا، بخلاف المسلمين العرب الذين يقول إنَّ مصر لم تسلس لهم قيادها بسهولة بل ثارت عليهم معتزة بشخصيتها الوطنية (ص18- 21، 27). ترى أين كانت هذه العزة الوطنية إزاء المستعمرات اليونانية والاحتلال اليوناني؟ ما أغرب عقلك يا دكتور طه حين تسوِّد ومعاني الوطنية التي تفقأ عين وقلب وعقل كل مكابرٍ عنيدٍ صفحاتك هنا عن الإسلام بمداد الحقد واللَّدَد في التشويه والرغبة الآثمة في التلاعب بحقائق التاريخ!